الحقيقة المروعة للغرب
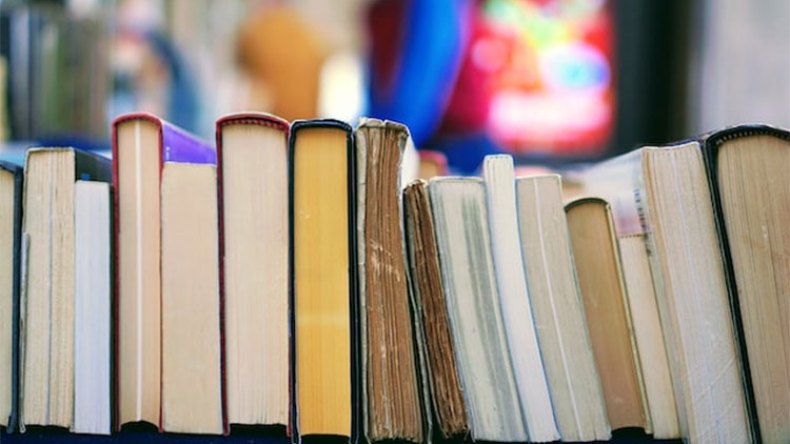
يقول “أ. توينبي”(1889-1975م) المُؤرِخ البريطاني الشهير الباحث في مسألة الحضارات: “… لقد أمكن ضرب الحصار على العالم الإسلامي، ففي أواخر القرن 16 و17 الميلاديين وُضع الطوق حول رقبة الفريسة. هذا الطوق، تُوج في الفترة الممتدة ما بين (1800-1915م) بالاحتلال كي يتسنى له فيما بعد، فرض ثقافته وحضارته؛ فالسيادة الغربية في بلد عربي أو إسلامي ما، معناها تسهيل انتقال المسلمين إلى المسيحية، أما فقدانها فينتج عنه حركة عكسية تماما (مذكور في: عبد الفتاح أحمد أبو زايدة، 1988م: 147).
كان المسلمون متفوقين فلسفيا واقتصاديا على الأوروبيين الغربيين من القرن 9 إلى 11 الميلاديين. وقد كان لهم تفوقٌ في مجال الجبر والهندسة والطب والفلسفة وغيرها من العلوم والآداب والفنون في ظل الدولة العباسية (750-1258م). كذلك، امتلكت الدولة العثمانية (1299-1924م) في القرون الأولى التي أعقبت ظهورها، حيوية حركية، مكنتها من تحقيق مَهمتها التاريخية؛ سطوة سياسية وعسكرية على أوروبا. ومنذ القرن 16م، لم تَعُدْ هذه الأخيرة ترى في الإسلام منافسا جديدا في ميدان العقل والعلم، وحين اقتربت الجيوش العثمانية من “فيينا” العام 1529م، أصبحت لهجتهم أكثر عدائية وحدة، إذ انبعثت القوالب القروسطية من جديد، مُركزة على وصف الإسلام بأنه “دين عنف”، وأن المسلمين معادون للعقل والعقلانية، إشارة إلى ما قامت به بعض الشخصيات الدينية البارزة التي راحت تجادل بأن دراسة الفلسفة اليونانية أمرٌ لا يتوافق مع القرآن الكريم، وقضى أكثرُهم بتحريم دراستها وأُحرقت الكتب ولُوحق المفكرون، وذلك مع نهاية القرن 11م.
كانت هناك مقاومة لفكرة وجود المطابع؛ إذ اعتبر العثمانيون أن المخطوطات تحظى بتقدير خاص، وأصدر السلطان سليم الأول (1512-1520م) مرسوما سنة 1515م، هدد فيه بإنزال عقوبة الموت بكل من بُقبَض عليه مستخدما مطبعة. وبالتالي، فهي لم تلتفت إلى ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين تفوق طاقتها العسكرية وتنمية قدراتها الحضارية، فوجد المسلمون أنفسهم معزولين عن تطورات البحث العلمي بعد أن زودوا الأوروبيين بالأفكار في عصر مضى، وشكل ذلك لحظة حاسمة في صعود الغرب وتفوقه على الشرق في القرن 18م بفضل القدرة الفكرية والتفوق في القوة العسكرية، بينما غابت الدولة العثمانية عن التقدم العلمي، فضلا عن مسايرته.
لم يطبع المسلمون كتابا واحدا من العام 1455م (عندما طُبع أولُ كتاب أوروبي) حتى العام 1729م (عندما طُبع أولُ كتاب عثماني). وفي القرن 18م، أنشأ العثمانيون بعض المطابع، لكنهم طبعوا القليل من الكتب… في ذلك القرن، طبع الأوروبيون الغربيون مليار كتاب، وطبع العثمانيون 50 ألف كتاب فقط!
لذا، عاش العالم الإسلامي حالة كسوف حضاري، وما ظل يحافظ عليه طوال القرون معرضا للمحو، جراء الفتن الداخلية، وتنازع الأهواء، وغياب أسس نظام الحكم، والتخلف العلمي، نتيجة جمود العقل، وتوقفه عن صناعة الفكر، والاكتفاء باجترار ما جادت به قرائح السلف من أفكار كانت وليدة بيئتهم، فَغفا في أحضان التقليد ونام على أحلام ماض مجيد. وحسب “أحمد. ت. كورو”: “… لم يطبع المسلمون كتابا واحدا من العام 1455م (عندما طُبع أولُ كتاب أوروبي) حتى العام 1729م (عندما طُبع أولُ كتاب عثماني). وفي القرن 18م، أنشأ العثمانيون بعض المطابع، لكنهم طبعوا القليل من الكتب… في ذلك القرن، طبع الأوروبيون الغربيون مليار كتاب، وطبع العثمانيون 50 ألف كتاب فقط! وبحلول العام 1800م، وصلت نسبة محو الأمية في أوروبا الغربية نحو 31%، مقابل 1% فقط في الإمبراطورية العثمانية، واستمرت فجوة الأمية في الاتساع”.
من ناحية أخرى، كانت السنوات الأخيرة من القرن 18م مليئة بالاضطرابات السياسية، وحافلة بالحركات التحررية، إذ اهتزت أنظمة وسقطت عروش، وكانت الثورة الفرنسية أثقل وزنا وأقوى عملا وأبعد أثرا؛ إذ خرجت أفكار الحرية والعدالة والمساواة والتقدم والإنسان والطبيعة، وانجر عن ذلك أن تغيرت أحوال فرنسا السياسية ونُظمُها الاجتماعية والاقتصادية، وتأثرت اقتصادات أوروبا بالثورة الصناعية؛ إذ تراكم العلم وظهرت الاكتشافات العلمية والاختراعات الحديثة، فكان لهذه التحولات أوقع الأثر في سائر الدول؛ إذ فرضت الحضارة الغربية سيطرتها على العالم واكتسبت مركزية بحكم الانتصارات العسكرية والتقنية والتنظيمية التي حققتها مع مطلع القرن 19م.
في خضم هذا المشهد، استفاق علماء الدولة ومفكروها، في العالم الإسلامي على مدهشات العلم ومنجزاته، وكان ذلك مناسبة لاكتشاف الذات، فراحوا يعاينون المعمار السياسي والاجتماعي والثقافي للغرب، وخَلُصوا إلى أن الظرف يستدعي مواجهة المدنية الزاحفة. وقد رأى بعضهم أن الإسلام قادرٌ على استرجاع فعاليته الحضارية إيمانا بأن الأمم لا تتداعى ولا تتدهور إلا بأسباب موضوعية ذات صلة بمنظور الفعل الحضاري.
لذا، جاءت الدعوة للإصلاح أو التجديد، تستدعيهما أسباب اجتماعية وسياسية؛ إذ كلما دب الفساد في النفس، فإن ذلك يوحي بالتلازم بين الفساد والتفكك والانحراف، وبين الإعراض عن الدين من جهة، وعدم وضع حلول للمشاكل التي تطرأ في حياة البشر من جهة أخرى. وإذا كان الإصلاح عند الفقهاء والعلماء، هو العودة إلى تطبيق دقيق للشرع وجعل أحكامه نافذة مهيمنة على أوجه الحياة، فإن التجديد -زيادة عن ذلك- هو فتح باب الاجتهاد لمواجهة المستجدات الطارئة في حياة المجتمع المسلم.
في هذا السياق، ظهرت مسألة التوافق مع العصر، إذ لمس بعضهم في الحضارة الغربية جوانب إيجابية، تتعلق أساسا بأسباب التقدم، وأنه لا ضير في الاستفادة من تجارب الأمم؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. يأتي ذلك من منظور الأخذ والعطاء، والتأثير والتأثر، وهي عملية ليست بالجديدة؛ لكن، يتم ذلك بعيدا عن الهجرة في التاريخ، أو الوقوع في “القابلية للاستعمار” الفكري والسياسي والأخلاقي للحضارة الغربية، من منطلق الإيمان بمسلمتين، هما: أن “لا إنسان بغير أخلاق”، و”لا أخلاق بغير دين” حتى وإن كانت الحداثة تهتم بالأخلاق، لكنها الأخلاق التي لا تستند إلى الدين، ولا يفرض الدين معاييره عليها؛ لأنها من منظورها تقوم على قوانين الطبيعة أو العقل، وأرادت تحويل الإنسان إلى مجرد مادة، وفصل نشاطه عن كل المعايير الأخلاقية، وبذلك تغدو المعرفة بالإنسان أشبه بالمعرفة بالظواهر الطبيعية.
خطاب الغرب الإنسانوي، موجهٌ أساسا إلى الرجل الأبيض الغربي، بينما تسقط تلك الحقوق أمام مصالحه كما يشهد على ذلك تاريخُه الاستعماري الإجرامي في حق الشعوب بالأمس كما اليوم، مما يشي بانتكاس أخلاقي ونزعة استعلائية عنصرية، كون “المركزية الأوربية” تعتبر أوروبا وامتدادها البشري/ الحضاري في شمال أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، هي العالم، بينما باقي الأمم مجرد فائض بشري وثقافي وحضاري، بل وصل الأمر ببعض الغربيين إلى حد اعتبار الأمم الأخرى “نفايات بشرية”!
تلك هي الحداثة، التي تبنتها عديد النخب في العالم العربي والإسلامي، قصد المشاركة في هذا التحول الذي تشهده الإنسانية على جميع الأصعدة، اقتصادا وسياسة ونظاما اجتماعيا بما فيه من زراعة وتجارة وصناعة ومؤسسات حكم وتشريعات ومؤسسات تعليم وتجمعات بشرية من الأسرة إلى القرية إلى المدينة إلى الأحزاب والنقابات. هذه النخب، انبنت قراءتها للحداثة على الاستنساخ والتقليد، ولم تَرَ فائدة حتى في التواؤم بين إسلام عقلاني ومبرأ من الجمود والتقليد.
وإذا كانت الضرورة العملية ومنطق جلب المصالح الدنيوية تقتضي اقتباس الجوانب المادية والعمرانية للمدنية الحديثة من الأمم الأكثر تقدما، فإنها تقتضي في الوقت ذاته الحفاظ على القيم والخصوصية الثقافية. لكن هذه النخب، تجاوزت أن معاصرة الفكر، تكمن في التزامها لحدوده، وعدم تنكرها لتراثيتها، لكنها تستهجن مرجعية المجتمع، وتترفع عن لغته، وأنْ لا فكر سوى ما ترومه ما يسمى”المدونة الحداثية”، وبالتالي، لا خلاص لمجتمعاتنا إلا باستعارة المنظومة الفكرية للآخر؛ والفكر الغربي -كما ترى– ما كانت له تلك الوثبة الحضارية إلا بعد أن نفض يديه من الدين إلى الأبد، وأن ثقافة مجتمعاتهم ليست إلا تعبيرٌ عن “الذهنية البدائية” التي لا ترقى إلى طور”التفكير المنطقي”.
وعليه، كانت نخب القرن 20م في العالم العربي – ومن أتى بعدها من النخب – تدعو إلى استنبات المدونة الحداثية في مجتمعاتنا العربية؛ ومن منظورها، أنه لا حلول لمشاكل هذه المجتمعات إلا باستنساخ الأنموذج الغربي شكلا ومضمونا، ومشروعا جاهزا. والغريب، أن هذه النخب تثور ضد دعاة التقليد من الإسلاميين/ الظلاميين بحجة سدهم مسالك التقدم والنهوض، ونسيت أنها ارتمت هي الأخرى في أحضان تقليد من نوع آخر مصدره مرجعية ومنظومة لا تنتمي إليها؛ علما أن التقليد يتفق مع الاقتداء في المعنى، لأن الاقتداء ليس إلا محاولة لتقليد القُدوَة، وهذا يعني وجود نوعين من الاقتداء، أحدهما اقتداء سيء مبني على جهل، واقتداء حسن مبني على علم، وكما أن التقليد يكون سيئا إذا كان المُقلد سيئا، فكذلك يكون الاقتداء ذميما إذا كانت القدوة ذميمة.
مهما يكن، فقد أسقط الغرب الاستعماري في عقول هؤلاء نزعة “الحداثة” بفعل وجوده العسكري والثقافي بين ظهرانينا منذ مطلع القرن 19م، ولا تزال هذه النزعة تعشش في عقول الكثير منذ تأسيس ما يسمى “الدولة الوطنية” من منظور أنها السبيل إلى التقدم واللحاق بالغرب، وشرطا ومقياسا للنجاح، رغم أن مفكري الغرب اعترفوا بفشل الحداثة وما بعدها، وكفروا بهما.
الحداثة علة إلحاقنا بالغرب
يقول البشير الإبراهيمي: “…إن ظلم الكلمات بتغيير دلالتِها كظلمِ الأحياء بتشويه خِلْقَتِهم، كلاهما مُنكر، وكلاهما قبيح، وإن هذا النوع من الظلم يزيدُ على القبح بأنه تزويرٌ على الحقيقة، وتغليطٌ للتاريخ، وتضليل للسامعين، ويا ويلنا حين نغتر بهذه الأسماء الخاطئة، ويا ويح تاريخنا إذا بُنِي على هذه المقدمات الكاذبة، ونغش أنفسنا إذا صدقنا.. يا قومنا، إن للواقع عليكم حقا، وإن للتاريخ حقا، وإن للأمة التي تعملون لها حقوقا، فأنصفوا الثلاثة من نفوسكم”. يأتي كلام إمامنا الجليل في سياق حديثه عن مصطلح الاستعمار الذي لم يأت ليعمر ويبني، بل، ليفكك ويقوض جوانب مادية كانت أو معنوية في مجتمعاتنا، واستعاضتها برموزه، وبخاصة الثقافية منها. ولا شك، أن مصطلح “الحداثة” في جوهره، هو عقيدة الغرب الجديدة “العلمانية” التي كانت إحدى آليات التقويض هذه.
وقد أصبح المصطلح، سائغًا تتداوله الألسن على اختلاف توجهاتها وتياراتها الفكرية، بعالمنا العربي منذ بداية القرن 20م، وعبره هيمن العقل الغربي على هؤلاء، وبذلك تحققت مقولة “جورج. هاردي” (1895-1979م): “… إن انتصار السلاح لا يعني النصر الكامل، إن القوة تبني الإمبراطوريات ولكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرار والدوام، إن الرؤوس تنحني أمام المدافع، في حين تظل القلوب تُغذي نار الحقد والرغبة في الانتقام، يجب إخضاع النفوس بعد أن تم إخضاع الأبدان”.
إن رؤية “هاردي”، هي التي يعمل الغرب على التمكين لها في منطقة الشرق الأوسط عن طريق ذراعه الكيان الصهيوني، اللصيق بالحضارة الغربية، إذ ربط مشروعه القومي منذ مطلع القرن 20م بالحداثة والعلم الأوروبيين، واعتبر نفسه طليعة التحديث الأوروبي في المنطقة وحامل لوائه، والمبشر بالعلوم والتكنولوجيا في منطقة يراها متخلفة وبدائية. وقد حقق الكيان اختراقا ثقافيا عبر التطبيع في العديد من دول المنطقة على مستوى النخب الحاكمة، ومن يدور في فلكها من المثقفين ممن تماهوا مع الغرب، وباتوا ينافحون عن الكيان ويدعون إلى التخلص من المقاومة ويرمونها بشتى الأوصاف.
النهارُ لا يحتاج إلى دليل
إن الصراع مع الغرب بالأمس كما اليوم، هو أوضح من شعاع الشمس في كبد السماء، صراع وجودي، وعقدي، وحضاري، إذ عمل –ولا يزال- على تجريدنا من وعيِنا وعقولنا وحاضرنا وتاريخنا، والدفع بمجتمعاتنا إلى طرح مرجعيتنا الدينية وتشرب منظومته الفكرية القائمة على أولوية العقل، واستقلاليته، واعتباره المرجع الأساس في البت في أمور الحياة والمجتمع، وفي كل ما يتعلق بالإنسان؛ فحداثته نادت بالأنسنة، وركزت على قيمة الشخص البشري في حد ذاته، بمعزل عن انتماءاته من عرقية أو دينية أو وطنية أو غيرها، والدعوة إلى بناء الدولة الحديثة على أسس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وأن الجميع متساوون تحت القانون.
هذا الغرب، حاول الظهور بمظهر حارس القيم الإنسانية، والمبشر بحقوق الإنسان وصون كرامته. وفي الحقيقة أن خطابه الإنسانوي، موجهٌ أساسا إلى الرجل الأبيض الغربي، بينما تسقط تلك الحقوق أمام مصالحه كما يشهد على ذلك تاريخُه الاستعماري الإجرامي في حق الشعوب بالأمس كما اليوم، مما يشي بانتكاس أخلاقي ونزعة استعلائية عنصرية، كون “المركزية الأوربية” تعتبر أوروبا وامتدادها البشري/ الحضاري في شمال أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، هي العالم، بينما باقي الأمم مجرد فائض بشري وثقافي وحضاري، بل وصل الأمر ببعض الغربيين إلى حد اعتبار الأمم الأخرى “نفايات بشرية”!
مهما يكن، يمكن تفهم انبهار”الطهطاوي”(1801-1873م) ومعاصروه بوثبة الغرب الحضارية، بل، حتى من أتوا بعدهم أمثال “طه حسين”(1889-1973م) الذي يُعد المؤسس الحقيقي للخطاب الحداثي العربي. لكن ما لا يُستَساغ، هو عقول بعض المثقفين التي لا تزال ترى في الغرب القدوة. وقد أماط طوفان الأقصى اللثام عن الوجه الحقيقي للخارطة الإدراكية للغرب التي تشكلت منذ المواجهات الأولى مع الشرق، خارطة تنضح بتغليب مبدأ العنف واستباحته على منطق العقل، وانحياز تام للجوانب المادية والمصالح البراغماتية على حساب قيم ومبادئ وحقوق، ظلت هذه الخارطة تُسمع الأصم بها، وقد فشلت في ضبط مسارها الأخلاقي تجاه ما يحدث للآخر- اللاغربي- وبخاصة المسلم.
أخيرا، بعد أن تبينت حقيقة هذه الخارطة الإدراكية للغرب، ومتلازمة “الحداثة” المُروعة، هل سيكون الطوفان ترياقا يزيل الغشاوة عن أعين هذه النخب؟ أليس لهم في “طه حسين” عبرة، حتى وإن استعاد وَعْيَه سنة قبل رحيله إلى دار البقاء . ربما، وقد خطا البعض خطوة ، حين بات يتحدث عن ازدواجية المعايير عند الغرب التي هي في الأساس من صميم بُنيته منذ أن بدأ في التشكل. نأمل ذلك، اللهم إلا إذا كانت مكلفة بمَهَمة، لما وراء الأكَمَة.
للمقال مراجع







